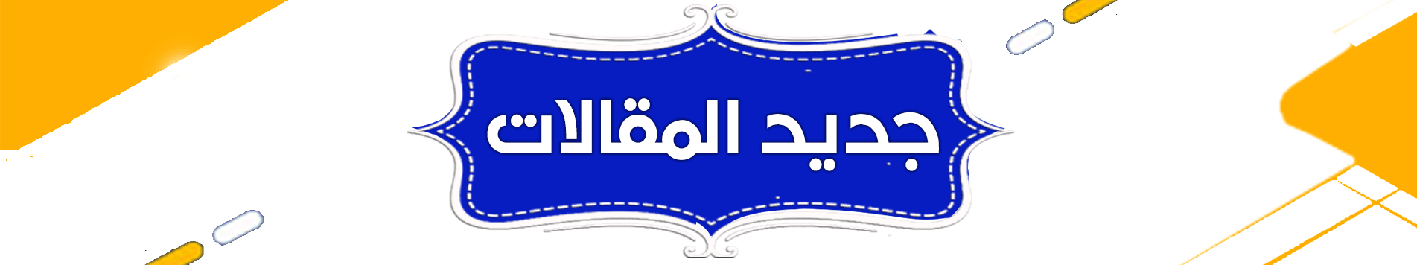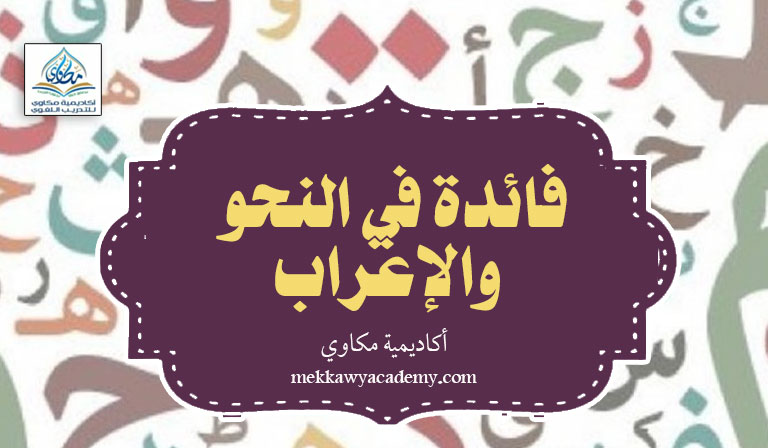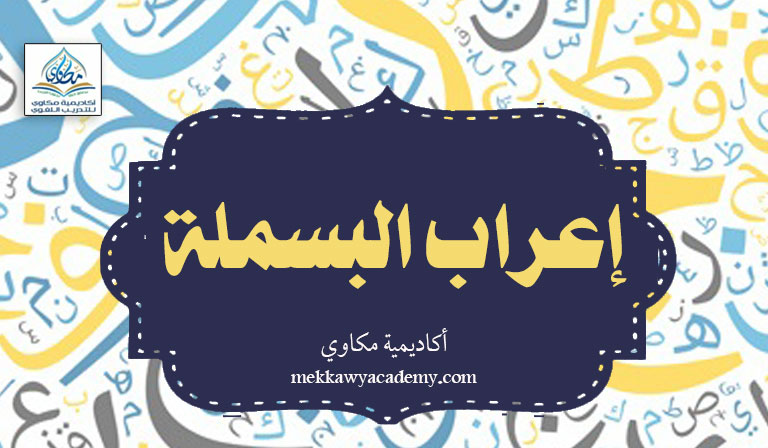المعربُ بحقّ الأَصل هو الاسمُ. والفعلُ المضارعُ محمولُ عليه.
وقالَ بعضُ الكوفيين: المضارعُ أصلٌ في الإعراب أيضًا.
الإِعراب دخل الكلام ليفرّق بين المعاني، من الفاعليّة والمفعوليّة والإِضافة ونحو ذلك.
وقال قُطرب-واسمه محمّد بن المُستنير-: لم يَدخل لعلّه وإنَّما دخلَ تخفيفًا على اللّسان.