شرح الكتاب سالف الذكرِ من خلال مجالس السماع المسجلة من مؤلف الكتاب نفسه عن طريق الإنترنت من خلال تطبيق الزووم، وقد سُجلت المحاضرات أيضًا طوال مدة الدورة، في ستّ محاضرات، وهذا يعني أنه ليس بينها وبين مؤلف الكتاب واسطة
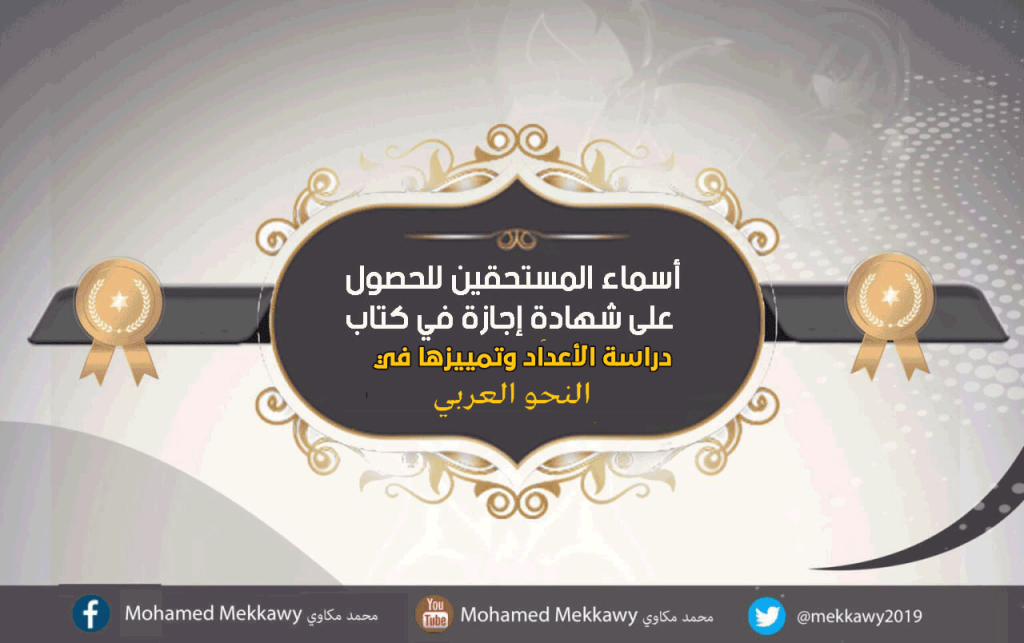
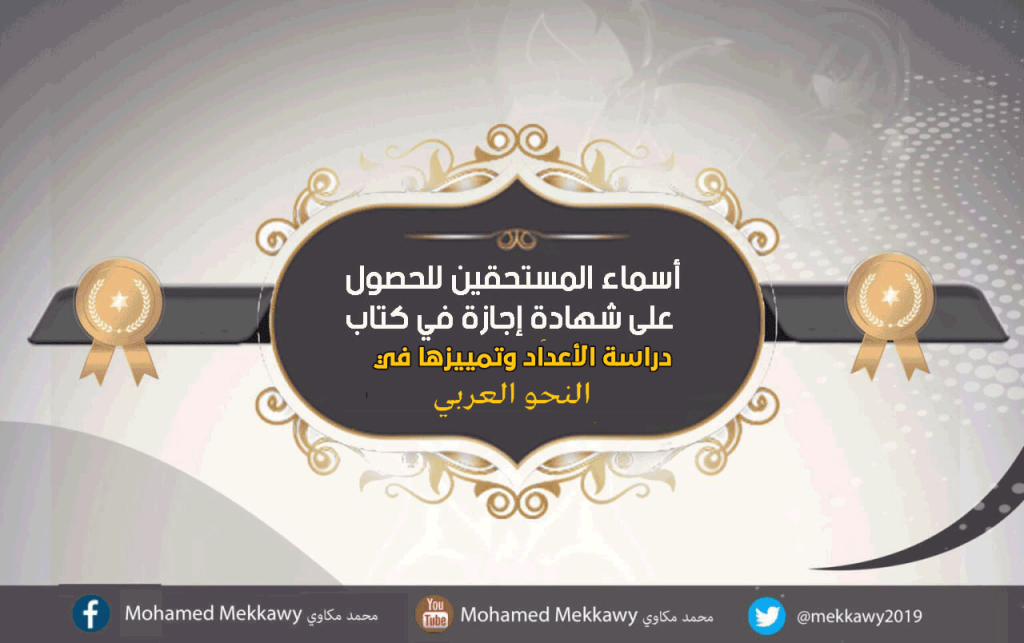
شرح الكتاب سالف الذكرِ من خلال مجالس السماع المسجلة من مؤلف الكتاب نفسه عن طريق الإنترنت من خلال تطبيق الزووم، وقد سُجلت المحاضرات أيضًا طوال مدة الدورة، في ستّ محاضرات، وهذا يعني أنه ليس بينها وبين مؤلف الكتاب واسطة

يتناول هذا المقال ملامح العلاقة العميقة بين النحو العربي والفقه الإسلامي، وكيف أسهم التفاعل بينهما في بناء الأحكام الشرعية على أسس لغوية رصينة. كما يبرز دور العلماء عبر العصور في توظيف القواعد النحوية لتوضيح المسائل الفقهية، وأهمية تعلم العربية كشرط أساسي للمجتهدين في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام.

اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء العقيدة، ولسان الوحي، ولغة القرآن الكريم الخالدة. تميزت ببلاغتها وثرائها، وحملت رسالة الإسلام إلى العالمين، فحافظت على هويتها بين اللغات، وأثبتت مكانتها عبر العصور.
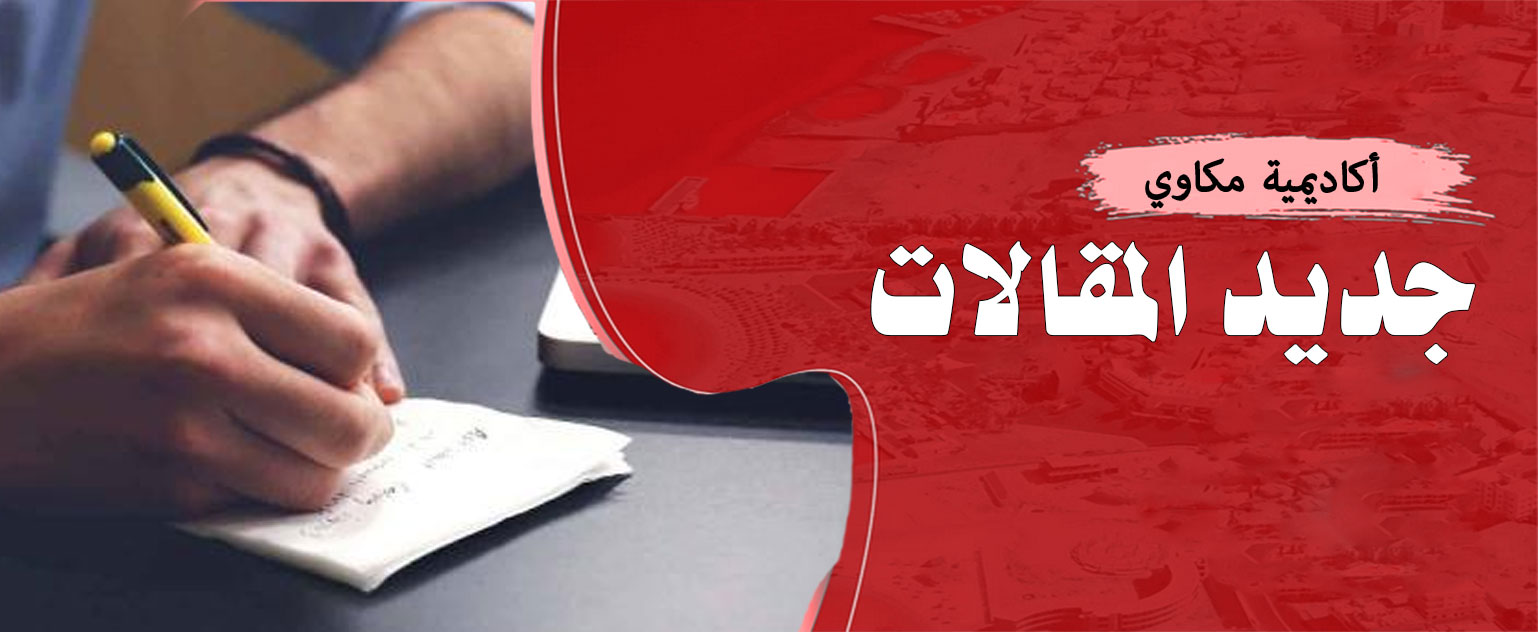
يتناول هذا المقال قضية لغوية مثيرة للجدل، تتعلق باستخدام الألقاب والمناصب للمؤنث مثل: “أستاذ” و”عضو” و”رئيس”، وهل يجوز تأنيثها إلى “أستاذة” و”عضوة” و”رئيسة”؟ وقد ناقش المقال قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة وانتقدها، معتمدًا على الاستقراء اللغوي، ومذاهب العرب في المشتقات والأسماء الجامدة، ومُستندًا إلى أقوال كبار العلماء مثل سيبويه وابن قتيبة والحريري وغيرهم.

يتناول هذا المقال توضيح الفروق الدقيقة بين كلمتي التِّيه و التَّيْه وما بينهما من دلالات لغوية، اعتمادًا على أقوال علماء اللغة مثل ابن منظور في لسان العرب والفيروزآبادي في القاموس المحيط. كما يوضح المقال خطأ شائعًا وقع فيه بعض المتكلمين والكتاب في الخلط بين هذه الكلمات، ويعرض المعاني الصحيحة مع شواهد قرآنية وتفسيرية.
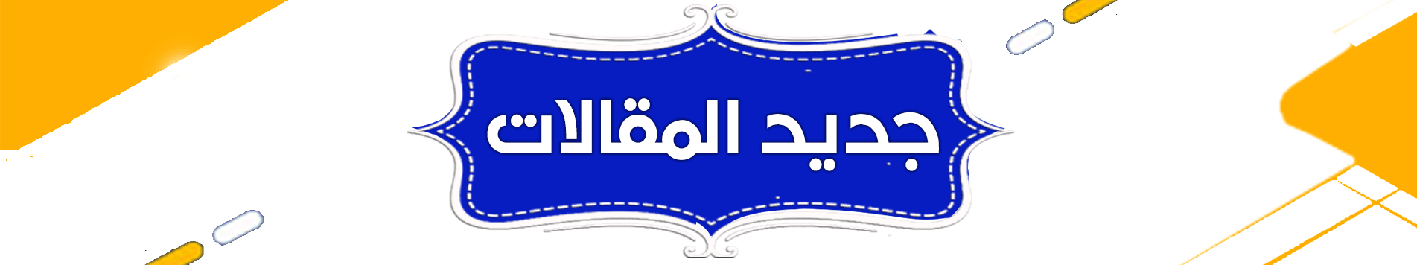
هذا المقال يستعرض أسباب شيوع الأخطاء اللغوية في اللغة العربية عبر التاريخ، بدءًا من العصور الأولى وحتى الواقع المعاصر، مع تحليل دور الاستشراق، التغريب، الإعلام، التعليم، والجامعات في إضعاف العربية، والتنبيه إلى ضرورة إحيائها وصونها كلغة القرآن الكريم.

شرح الكتاب سالف الذكر من خلال مجالس السماع المسجلة من مؤلف الكتاب نفسه عن طريق الإنترنت من خلال تطبيق الزووم، وهذا يعني أنه ليس بينها وبين مؤلف الكتاب واسطة، وقد دخلت الاختبار في هذا الكتاب
(*) الواو(الاسم): وهي واوالجماعة، وهي ضمير بارز يتصل دائمًا بالفعل الماضي (كَتَبوا) والمضارع (يكتبون) والأمر (اكتبوا) (*) الواو(الحرف): ولها 6 أقسام: 1- واوالعطف:2-واوالمعية:3- واوالإشباع:4- واوالقسم:5 ـ- واوالاستئناف:6- واوالحال

لماذا اختصت بعض الأفعال بحرف معين كفعل قصد الذي يتعدى بـ (إلى) وفعل عمد المتعدي باللام على الفصيح؟

اختلفت عباراتُ النحويين في حدّ الفعل.
فقال ابن السّراج وغيره: حَدّه كلُّ لفظٍ دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمانٍ محصّل. وهذا هو حدّ الاسم، إلاّ أنّهم أضافوا إليه لفظة ((غير)) ليدخلَ فيه المصدر، وإذا حذفتَ ((غير)) لم يدخل فيه المصدر؛ لأنّ الفعل يدلُّ على زمانٍ محصّلٍ، ولأنّ المصدر لا يدلّ على تعيين الزّمان. وإن شئت أضفت إلى ذلك دلالة الوضع، كما قيّدت حدّ الاسم بذلك،