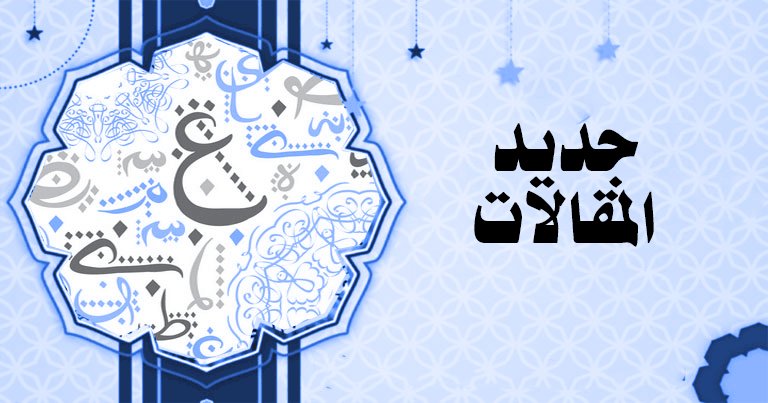• يقال خطأً: النساء يعفُنَّ (من العفو) بضم الفاء وتشديد النون.
والصواب أن يقال: الرجال يعفونَ، والنساء يعفونَ.
فالفعل الأول معرب مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعله، ووزنه: يفعونَ.
والثاني مبني على السكون، ونون النسوة فاعله، ووزنه: يَفْعُلْنَ.