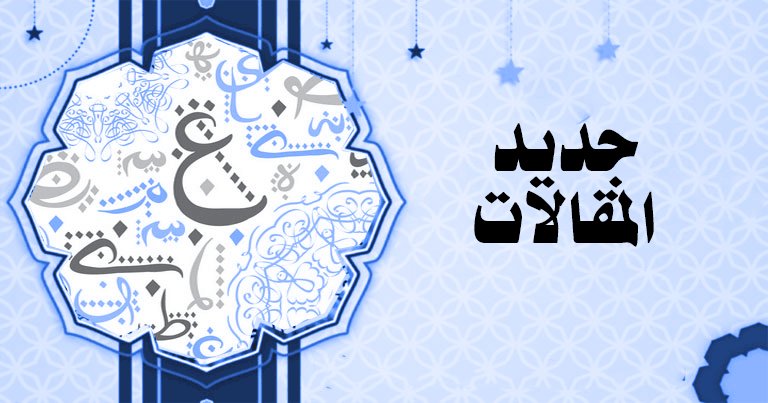النّحو العربيّ: التّعريف النّشأة
مقدّمة:
المتتبع للغة العربية يجد أنّ النحو لا يكاد يفارق مؤلفا من مؤلفات القدماء خاصة اللغوية منها، وهذا ينمّ عن المكانة التي حضي بها الدّرس النحويّ قديما وحديثا، فمنذ عهد أبي الأسود الدؤلي والجهود قائمة من أجل تعلّم النحو وتعليمه، وانطلاقا من هذا كانت هذه الدارسة للنحو من جوانب ثلاثة: التعريف والنشأة والأهميّة رغبة في الوقوف على جملة من أراء العلماء والباحثين حول النحو، ومحاولة للتوفيق بين هذه الآارء وتخريجها في حلة تساعد القارئ والباحث عن المعلومة.
تعريف النّحو:
النّحو لغة: مصدر نحا، فيقال: نحا إلى الشيء ينحو نحوا: إليه وقصده، ومن معاني النحو:
القصد، والطريق، والمثل، والمقدار.
ورد في معجم لسان العرب لابن منظور، أنّ النّحو ” إعراب الكلام العربي، والنحو: القصد
والطريق، ويكون ظرفا ويكون اسما، نحاه ينحوه ويَنْحاهُ نحوا ونْتَحَاهُ، ونحو العربية منه، وإنما
هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتشبيه والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، أو إن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحوا كقولك: قصدت قصدا، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم من خلال هذا التعريف لابن منظور نرى أنّه يربط النحو بالإعراب، أي ينحصر على أواخر الكلم.
وقال الأزهري: قال الليث: النحو القصد نحو الشيء، نحوت نحو فلان، إذ قصدت قصده،
قال: وبلغنا أنّ أبا الأسود وضع وجوه العربية وقال للناس: أنحوا نحوه فسمي نحوا، وقد جمع
الداودي معاني النحو في اللغة فقال:
للنَّحوِ سَبْعُ معَانِ قد أَتَتْ لُغَةٌ =جَمَعْتُها ضِمْنَ بَيْتٍ مُفْرَدٍ كَمُلا
قَصْدٌ، ومِثْلٌ، ومِقْدارٌ، ونَاحِيَةٌ =نَوْعٌ، وبَعْضٌ، وحَرْفٌ، فاحفظ المثلا
من خلال هذه التعريفات اللغوية للنحو نستنتج أنّ النحو هو القصد والطريق.
النّحو اصطلاحا:
اختلف النحويون في تعريف “النحو” وتعددت تعريفاتهم، فمنهم من يذهب إلى أنّ النحو مشتق من قولهم: أنحُ هذا النحو، أي: ذلك الاتجاه الذي أ ا رده عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من ذهب إلى أنّه انتحاء سمت كلام العرب الفصيح ومنهم من يرى أنّه علم قواعد اللغة كغيره من علم النحو في أي لغة من لغات العالم 4، ومن خلال هذا التقديم الموجز يتضح أنّ التعريفات تنوعت وهي كالتالي:
لقد ذكر سيبويه (ت 180 هــ) مصطلح النحويين في الكتاب، ولم يذكر تعريفا اصطلاحيا للنحو العربي، وهو أول كتاب لغوي وصلنا من مرحلة التدوين، وذلك بسبب انشغاله بجمع اللغة وتوصيفها واستنباط القواعد النحوية منها ثم تدوينها في الكتاب.
أما ابن سراج (ت 316 هــ) فقد كان له سبق في وضع تعريف للنحو العربي، وذلك في كتابه
الأصول في النحو، حيث قال: النحو إنّما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة، فباستقراء كلام العرب فاعلم: الفاعل رفع والمفعول به نصب وأنّ الفعل مما عينه: ياء أو واو تقلب عينه من قولهم: قام وباع 6. وفي هذا التعريف ليس هناك تحديد لحقيقة النحو بقدر ما هو تعريف بمصادر، وبيان الهدف من تدوينه ودراسة.
أما ابن جني (ت 392 هــ) فيقول في تعريف النحو: هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره، كالتشبيه، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة والنسب، والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، أو إن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها، وهي في الأصل مصدر شائع أي: نحوت نحوا كقولك:
قصدت قصدا، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أنّ الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء، أي: عرفته، ثم خصّ به علم الشريعة من التحليل والتحريم، وكما أنّ بيت الله خصّبه الكعبة وإن كانت البيوت كلها لله.
هو في هذا التعريف يميز بين نوعين من التناول في دراسة الكلمة ضمن هذا العلم:
أولهما (الإعراب) الذي يعنى بتغير أواخر الكلمة بسبب انضمامها إلى غيرها في تركيب
المعنى، وهو داخل فيما اختص به النحو.
والثاني هو ما يعنى بدراسة بنية الكلمة مفردة، وهو الذي اختص به الصرف ويعرفه العكبري (ت 616 هـ) بقوله: اِعلم أنّ النحو في الأصل مصدرٌ نحا ينحو إذا قصدَ، ويقال: نحا له وأنحى له، وإنّما سمي العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه وبنائه “نحواً” لأنّ الغرض به أن يتحرّى الإنسان في كلامه إعرابا وبناءا طريقة العرب في تلك وحدّه عندهم أنّه علمٌ مستنبط بالقياس ولاستقراء من كلام العرب، والقياس ألاّ يثنّى ولا يجمع لأنّه مصدر، ولكنّه ثُني وجُمع لما نقل وسُمي به، ويجمع على أنحاء ونحو”.
والعكبري في هذا التعريف يسير على خطى ابن سراج وابن جني ويرى أنّ الإعراب جزئ من النحو وليس هو النحو كله.
وعرفه ابن عصفور (ت 669 هـ) فيقول: النحو علمٌ مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تتألف منها فيحتاج من أجل ذلك إلى تبيين حقيقة الكلام وتبيين أجزائه التي يتألف منها وتبيين أحكامها.
وابن عصفور في هذا التعريف قيّد هذا العلم بكونه مستخرجا، وأنّ المراد بالمقاييس الواردة فيه: القواعد الكلية، وقد عقّب الأشموني (ت 918 هـ) على التعريف بعد أن أخذ به بقوله: فعلم أنّ المراد هنا بالنحو ما ي ا ردف قولنا: علم العربية لا قسيم الصرف.
وقد عرفه ابن منظور (ت 686 هـ) تعريفا مشابها مضمونا للتعريف السابق، قال: العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذ واتها، وما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعنى من الكيفية والتقديم والتأخير ليتحرز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم، وفي الحذو عليه.
وممن عرّفوا النحو باختصار ابن حيان الأندلسي (ت 745 هـ) فيقول: النحو علم بأحكام العربية إفرادا وتركيبا.
فالنحو بهذا التعريف شامل للنحو والصرف، فالصرف قسيم منه وليس قسيما له وهذا ما جرى عليه سيبويه والمتقدمون فالأحكام الإفرادية هي موضوع الصرف، والأحكام التركيبية هي موضوع علم النحو.
وأول من عرف النحو بشكل يجعله مستقلا عن علم الصرف هو الشيخ خالد الأزهري (ت 905 هـ)، حيث قال: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وبناءً وموضوعه الكلمات العربية، لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية من حيث الإعراب والبناء، وغايته الاستعانة على فهم كلام الله تعالى ورسوله، وفائدته معرفته صواب الكلام من خطئه.
فالأزهري بهذا التعريف فصل بين النحو والصرف، وبين غاية النحو وهي فهم كتاب الله تعالى، كما أورد الفائدة من هذا العلم وهي تقويم اللسان وصونه من الخطأ.
ويأتي الفاكهي (ت 972 هـ) ليعطيه صورته النهائية بقوله: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءً، 14 وهو هنا جاء بعبارة أواخر الكلم التي هي أوضح في الدلالة على المراد من النحو.
من خلال تعريفات القدامى للنحو نجد أنّهم يتفقون على التعريف اللغوي، أما الاصطلاحي فقد
اختلفوا فيه فمنهم من مزج بين علمي النحو والصرف في تعريفه، ومنهم من عرفه مستقلا،
فالنحو في اللغة عندهم هو القصد والاتجاه والطريق، أما في الاصطلاح فقد تفاوتت التعريفات، فذهب بعضهم إلى أنّ “النحو” هو انتحاء سمت كلام العرب في المفردات والمركبات، وذهب غيرهم على أنّه علم يُعرف به أحوال أواخر أبنية الكلم العربية إفرادا وتركيبا، ويرى آخرون أنّ النحو يطلق على الصرف كما يطلق على الإعراب ، فالخلاف عند القدامى في ماهية النحو، لا في غرضه.
ونجد للمحدثين أيضا أ ري في تعريف النحو وسأذكر بعضا منهم على سبيل التمثيل لا الحصر، حيث يقول مصطفى الغلاييني الدال على النحو هو الإعراب ، والإعراب هو النحو، ويقول:
وهو ما يعرف اليوم بالنحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء أي: من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب عليه أن تكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جرّ، أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، انتظامها في جملة ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية.
الغلاييني في تعريفه مزج بين النحو والإعراب وهذا ليس حديثا فقد سبقه في ذلك غيره من
العلماء.
تحدث عباس حسن في مقدمة كتابه النحو الوافي عن فضل النحو ومكانته فيقول:” النحو وكما وصفته من قبل دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى، منه تستمد العون، وتستلهم القصد، وترجع إليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها، ولن نجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو، أو يستغني عن معونته، أو يسير بغير نوره، وهداه وهذه العلوم النقلية عن عظيم شأنها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها، بغير هذا العلم.
ويقول أيضا: إنّه النحو وسيلة المستعرب، وسلاح اللغوي وعماد البلاغي وأداة المشرع والمجتهد والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعها، فليس عجبا أن يصفه الأعلام السابقون بأنّه”
ميزان العربية والقانون الذي تحكم به كل صورة من صورها.
ويعرفه فاضل صالح السامرائي: هو علم يُعنى أول ما يعنى بالنظر في أواخر الكلم وما يعتريها من إعراب وبناء، كما يُعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهميّة كالذكر والحذف، والتقديم، والتأخير، وتغيير بعض التغييرات غير أنّه يولي العناية الأولى لإعراب، وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة لا تقلّ أهميّة عن كلّ ما بحثه النحاة. نجد في تعريف السامرائي إلماما لجوانب عدة من النحو، ولم يقصره فقط في الإعراب وهذا النوع من التعاريف يتسم بالعلمية..